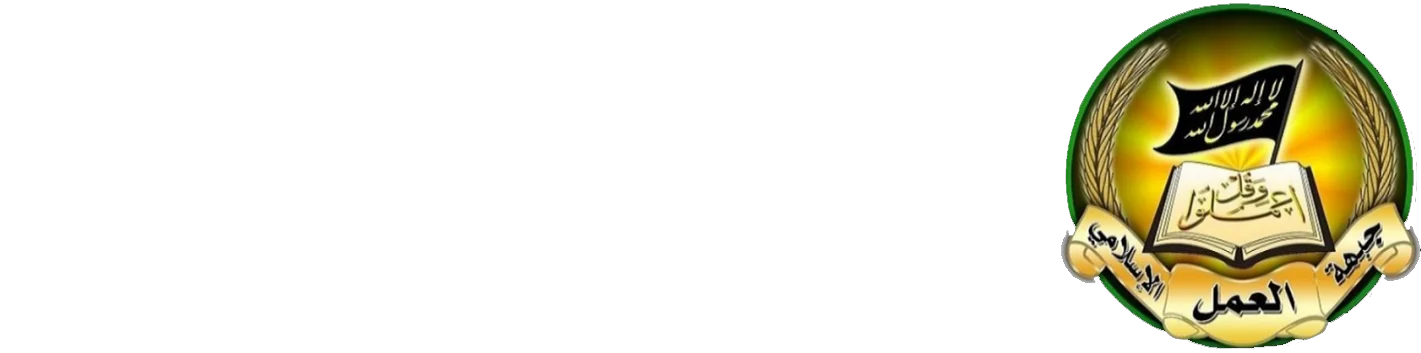اخبار لبنان
بعد الدمار الواسع الذي لحق بالبنى التحتية في القرى الأمامية جنوب نهر الليطاني، ولا سيما في مدة الثمانين يوماً التي تلت الحرب الأخيرة، يعود ملف حقوق لبنان في مياه نهر الوزاني إلى الواجهة.

بعد الدمار الواسع الذي لحق بالبنى التحتية في القرى الأمامية جنوب نهر الليطاني، ولا سيما في مدة الثمانين يوماً التي تلت الحرب الأخيرة، يعود ملف حقوق لبنان في مياه نهر الوزاني إلى الواجهة. وهذا الحق، وإن بدا بديهياً من حيث المبدأ، إلا أن تثبيته وحمايته يتطلبان جهداً استثنائياً وإرادة سياسية شجاعة من الدولة اللبنانية.
تاريخياً، تعود القضية إلى عام 1955 حين قدّم الموفد الأميركي إريك جونستون مشروعاً لتقاسم مياه نهر الأردن وروافده (الحاصباني، بانياس، اليرموك).
وفقاً للمشروع، كان مطلوباً من لبنان أن يكتفي باستخدام كمية محدودة من مياه الوزاني لا تُجاوز الـ35 مليون متر مكعب سنوياً، ضمن خطة توزيع تمنح إسرائيل الحصة الأكبر، يليها الأردن وسوريا، فيما تُترك للبنان الحصة الأقل. ورغم أن المشروع طُرح تحت شعار «تنمية إقليمية مشتركة»، إلا أن جوهره كان تكريس هيمنة إسرائيل على معظم موارد النهر، الأمر الذي دفع لبنان في النهاية إلى رفضه.
اليوم، تعود القضية نفسها بصيغ مختلفة، إذ برزت تصريحات متباينة لعدد من النواب اللبنانيين: بعضها يقدّر حصة لبنان بـ25 مليون متر مكعب، وأخرى ترفعها إلى 40 مليون متر مكعب. فيما المفارقة أن هذه الأرقام أقل بكثير مما رفضه لبنان قبل سبعين عاماً.
يبقى موضوع الحقوق في مصادر المياه من أكثر الملفات تعقيداً، إذ لا يوجد في القانون الدولي ما يُسمّى «الحق البديهي للدولة المشاطئة» في استخدام مياه الأنهار، بمعنى أن الأمر لا يُحتسب آلياً وفقاً لمعايير ثابتة ومعتمدة عالمياً. صحيح أن العوامل الجغرافية – مثل كمية المياه التي تنبع من أراضي الدولة، وطول مجرى النهر داخلها، وحجم الحوض المائي – تشكّل عناصر أساسية في تقدير الحقوق، إلا أنها ليست العوامل الحاسمة.
بحسب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وسيم ضاهر، فإن «حق الدول المشاطئة في استغلال مياه الأنهار العابرة للحدود يتحدد بما يضمن تلبية حاجاتها، مع احترام حقوق الدول الأخرى على قاعدة الحاجات ومبدأ حسن الجوار. أما العوامل الطبيعية والجغرافية، رغم أهميتها، فتبقى أساساً غير حاسم لتثبيت الحقوق ما لم تقترن بقوة تحميها».
ويضرب ضاهر مثالاً على ذلك من خلال النزاع حول تقاسم مياه النيل بين مصر وإثيوبيا، إذ اختلف البلدان في كيفية احتساب حاجة مصر من المياه لتأمين أمنها الغذائي، فيما مضت إثيوبيا في بناء السدود من دون اتفاق مع باقي الدول المشاطئة، مستندةً تارةً إلى قوتها الذاتية، وتارةً أخرى إلى ضعف الآخرين في الدفاع عن حقوقهم. ويخلص إلى أن أي اتفاق حول المياه لا يُبنى على المعايير التقنية وحدها، بل يحتاج إلى عنصر القوة، إذ إن «اتفاقات المياه هي في جوهرها نتيجة مفاوضات أو حروب، يستخدم فيها كل طرف ما يمتلكه من أوراق قوة».
المصدر: الأخبار